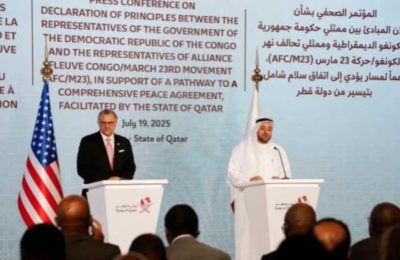في ترذيل عشرية القطاع وواجب المصالحة الثقافية
في ترذيل عشرية القطاع وواجب المصالحة الثقافية
أو حتى لا يقتلنا الصمت مرتين
بقلم يونس السلطاني
يقال إن الصمت لا يعني القبول دائما، فأحيانا يعني أننا قد تعبنا من التفسير وربما أيضا تأبطنا الصبر والصمت حين اصطدمنا بواقع عشرية ما اصطلح على تسميته بثورة الحرية والكرامة. ثورة كشفت عن حقد كبير تجاه الشأن الثقافي على وجه التحديد فكلما تعفن الوضع العام كلما تعالت أصوات بعينها منادية بتحويل اعتمادات وزارة الثقافة أو إلغاء وجودها أصلا. ولا نعلم حقيقة ماذا اقترفت هذه الوزارة من ذنوب حتى تكون، دون غيرها من الوزارات، عرضة لهجمات أعداء الحرية والإبداع من ناحية وانتقادات “المناوئين المتحضرين” من جهة أخرى. وهنا تكمن خطورة هذا الشق الذي يترصد الهفوات والعثرات حتى يقفز بكل ما أوتي من بروبقندا صارخا في وجه القطاع وأهله عساه يفوز بوسام المدافع الشرس عن مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، تلك الفزاعة التي بات يتوسلها العديد من الأفراد وبعض الهياكل لتحقيق مصالح مادية أو أدبية.
مرّ على رأس وزارة الثقافة بعد “الثورة” عديد من الوزراء بدءا بعز الدين باش شاوش فمهدي المبروك مرورا بلطيفة لخضر ومراد الصقلي وسنية مبارك فمحمد زين العابدين وصولا – منذ أيام- إلى شيراز العتيري.. كل الوزراء تقريبا غادروا أسوار الوزارة غير مأسوف عليهم ولو بتفاوت. هم وزراء لم يستمعوا إلاّ لأنفسهم ولم يأبهوا لأيّ نصح أو فكرة. وزراء بدوا في ظاهرهم أساتذة جامعيين برتبة وزراء يعرفهم الجميع وفي باطنهم نظر وتحقيق لدى من باشروهم وخبروا بعد تقييم موضوعي تواضع تجربتهم. ويعزى بعض التفاوت البسيط إلى فترات الحكم التي تختلف من وزير(ة) إلى آخر وأيضا لشرعية الحزب صاحب المرتبة الأولى برلمانيا أو ما يعرف بالسياج الحزبي الضامن لاستقرار حكومة أو أحد أعضائها. وفي الحقيقة كانت كل الأحزمة الحزبية طيلة هذه العشرية ناسفة لأي عمل وزاري أو حكومي عموما، فلم يبق في ذاكرة التونسيين سوى علامات الفشل.
وفي هذه الورقة الموجزة نقف عند تأمل الشأن الثقافي ما بعد “الثورة”، حيث يُجمع كل المتابعين- باستثناء الأيتام من أصحاب المصالح- أن جميع الوزراء قد جانبوا المهام المناطة بعهدة الوزارة منذ سنوات التأسيس. مهام مغايرة لأي مؤسسة رسمية أخرى بحكم أن طبيعة اشتغالها لا تقتصر فقط على المقررات الإدارية بل تشمل وهذا هو الأهم، الرؤية والإستراتيجيا والبرامج الكفيلة بمسايرة الحركة الثقافية ودعمها وتشبيك مجالاتها الفنية حتى يرتقي الفرد بالذائقة المجتمعية ومن ثمّ تتحصّن العقول من شوائب التكلّس والظلام. ذلك أن السادة الوزراء المذكورين أعلاه والذين حققوا أمنياتهم ذات قدر “ثورة” في الحصول على رتبة وزير(ة) لم يكونوا في حقيقة الأمر في مستوى تطلعات الساحة الثقافية وهذا ليس من باب التجنّي عليهم نساء ورجالا ولا يتطلب تمحيصا في محصّلة المساحات الزمنية التي قضّوها مترئسين معسكر أعوانهم أو متجولين هنا وهناك وسط معسكر المهللين.. هي عشرية بأيامها ولياليها، بضجيج صيفها ورتابة شتائها اتسمت بالشعارات الرنانة وهُيّئت لها كل الوسائل للفوز بصورة ناصعة ليس للمشاريع الثقافية والحركة الإبداعية المترهّلة وإنما لصورة السادة الوزراء. وزراء استقطبوا أنظار كل العدسات والإذاعات.. فلا نخال مثلا وجود مواطن لم يشاهد وزراء الثقافة على إحدى القنوات أو مرورهم بإحدى الإذاعات، فإن لم يكن ذلك صباحا فحتما سيكون مساء.. نراهم مبتسمين، مخاطبين، معوّمين، مرتجلين،عالمين وممنّين. لا نخال أن المواطن التونسي يحفظ من العام 2011 إلى اليوم أسماء وزراء البيئة وما أدراك ما البيئة أو أسماء وزراء أملاك الدولة وما أحوجنا لضبطها أو كل أسماء وزراء الفلاحة ونحن نعيش أزمة السميد وغيره.. الوحيدون الذين لا ينسى المواطن أسماءهم هم وزراء الثقافة.
اهتمامهم بالظهور، وإن بالبيض المسلوق، عزل الثقافة عن روادها وأربك السير العادي للمؤسسات وكل الهياكل ذات الصلة.. موائد إفطار واجتماعات ماراطونية أرهقت المدراء مركزيا وجهويا وحصيلتها بقايا صور.. غابت الرؤية طيلة عشر سنوات للإحاطة بالمثقفين في مختلف المجالات الفنية بدءا بالكتّاب الأكثر تضررا وقد ساءت أوضاعهم الاجتماعية والمعنوية بالنظر إلى تراجع دعمهم وتجاهل خلاص مستحقاتهم، الزهيدة، عند المسامرات أو عند تحبيرهم للنصوص الأدبية في مجلة الحياة الثقافية أو “فنون”. ولعل غياب تفاعل الوزراء مع مشاغل اتحاد الكتاب ورابطة الكتاب الأحرار ونادي القصة وغير ذلك من قبر للمبادرات الفردية الأدبية، إذا ما استثنينا في السنتين الأخيرتين مجهود محمد المي في منتدى الفكر التنويري، فكلها ملامح تقيم الدليل على تهميش وزراء ثقافة ما بعد “الثورة” للكتّاب إن لم نقل عداء غير معلن.. مرورا، بقطاع المسرح الذي ضحّت أجيال الفرق الجهوية ومراكز الفنون الدرامية من أجل تجذيره والرفع من مكانته للأسف نزلوا به وبرواده إلى أسفل السافلين نتيجة هذا الإسهال “المسرحي” المقرف في منح الأصول التجارية التي لا تسمن ولا تغني من هواجس أهل الفن الرابع ولا بهموم الشباب التائق إلى الخلق عموما… وصولا إلى قطاع الفنون التشكيلة الذي زادت حالته تدهورا بعد أن تداخلت المهام بل ان أمره فوّض تقريبا إلى الروابط والاتحادات في إطار “الانفتاح” على المجتمع المدني، واختزل القطاع، إذا ما استثنيا استحسان نقل الأرشيف وتخزينه بشكل آمن، في بعض المعارض المعدودة، فلا عزاء لدولة لا تحترم رساميها.. ولا يفوتنا بالمناسبة أن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الفرقة الوطنية للفنون الشعبية وإلى كافة المبدعين، في شتى المجالات، ممن حلموا بقانون يحميهم أو مساكن اجتماعية تأويهم.
إن “الديمقراطية التشاركية” و”ترسيخ اللامركزية الثقافية” و”دمقرطة الثقافة” و”الفعل الثقافي” وغيرها من العناوين الجميلة بقيت متناثرة في فكر الوزير(ة) أو المستشارين يتفننون في حياكة شعارات رنانة تلتقطها على جناح السرعة الموجات الإذاعية ويسهر جهابذة البلاتوات التلفزية على تحليل مضامينها.. نذكر من ذلك المشروعين “مبدعون من أجل الحياة” في حكومة الحبيب الصيد و”تونس مدن الفنون” في حكومة يوسف الشاهد. فماذا تغيّر في تونس العميقة؟ هل تم نفض الغبار عن مآثر تراثنا المترامي في القرى ؟ وهل فاز شباب أريافنا المفقرة بنصيب كعكعة ما فاض من فنون؟ ثم ماهي فلسفة المشاريع الثقافية أو بالأحرى الحفلات التنشيطية التي تم تمويلها في إطار هذين المشروعين؟
وفي سياق متصل أيضا بالارتجال، أقدمت وزارة الثقافة على بعث “إحداثيات ثقافية” والحال أنها أقرب إلى وزارات أخرى من ذلك “معهد تونس للفكر والفلسفة” و”معهد تونس للتاريخ والأنثروبولوجيا” أو ربما هي أقرب أن تكون ضمن أقسام بيت الحكمة الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة وذلك من أجل تخفيف الضغط على موارد وزارة الثقافة.. مؤسسات حلّ “الاهتمام بها” محلّ مؤسسات التنشيط الثقافي والمكتبات العمومية تلك التي ترعرعنا فيها وصقلت مواهبنا وكانت هديّة دولة الاستقلال للناشئة والشباب. وتزخر تونس اليوم بأسماء كبيرة في الأدب والموسيقى والسينما والمسرح والرسم ممن مرّوا ذات سنوات بفضاءات دور “الشعب” والثقافة والمكتبات باعتبارها المؤسسات الفعلية القادرة على احتضان الطاقات والإحاطة باليافعين، إلى جانب دور المؤسسات التربوية والكشافة والمصائف والجولات..
لذلك فإن تفعيل شعار التمييز الإيجابي للثقافة كان يفترض أن تتجه بوصلة وزراء ثقافة ما بعد “الثورة” إلى العمق المجتمعي لا أن تقتصر على جماهير قرطاج السينمائية والمسرحية والموسيقية ومؤخرا الشعرية والخزفية.. فهي جماهير “نيّرة” لم تكن يوما عرضة للاستقطاب.. وأن الخشية من التطرف كامنة في تلك الأحياء ذات الكثافة السكانية والقرى والأرياف الحدودية، فكلما توفرت أدوات الفعل الثقافي هناك – في هذه المناطق- كلما كان المسار آمنا. مسار الفرد/ المواطن السوي درءا لمخاطر الغلوّ والتطرف.
بعيدا عن “التوجهات/ الفيترينة” وداخل أروقة الوزارة، فإن منسوب “الخراب” أيضا كان على نفس الارتفاع إن لم يكن أكثر ركاما.. فقد برزت مظاهر الكره والحقد بين أبناء البيت الواحد وذلك نتيجة شعار هؤلاء الوزراء ومستشاريهم “فرق تسد” فتفرق الأشخاص وتشتت الأفكار. كما أن السادة الوزراء حرصوا على إبعاد كل الكفاءات ممن خبروا الشأن الثقافي تسييرا واستشرافا وهو ما أربك الإدارة وأحبط آمال الجديين من المسؤولين والأعوان على حد سواء. فلا أحد في الوزارة والمؤسسات الراجعة بالنظر ضامن لبقائه، بشكل دوري ومع كل وزير، في الخطة أو المهام الموكولة إليه.. فربما يكون هنا صباحا ليصبح هناك عند المساء. ربما ينجح لكفاءته مع وزير ويبعده وزير آخر بالمجان فتحبط آماله وتنهار الإدارة.. وما استقرار أي موظف بمكتبه ومهامه إلا بالنظر إلى خلوّ التقارير الحينية للمخبرين من ذكر اسمه إن كان قد تفوّه بذكر الوزير(ة) في حانة أو رواق أو أن مظهره لم يرق لأحد أفراد طاقم/ حزام كل وزير(ة) وما أكثرهم.. فلم تعد بعد “الثورة” محاصرة الفنان أو الإطاحة بمدير أو موظف من درجة ثالثة تستوجب النظر والتحقيق في مخالفة أو رفض لتنفيذ التوصيات الحكيمة، فقط قد يكون ذلك رهين إرسالية قصيرة ترد على شاشة وزير(ة) أو مستشاريه. وهنا لابد من التنويه بالطرف النقابي لما بذله من جهود –طيلة عشر سنوات- لرفع بعض المظالم وردع استخفاف الوزراء بأبناء “الدار” واستقدامهم لعدد مهول من المستشارين ومن العديد من أصدقائهم -إلحاقا وعقودا- دون تبرير الحاجة إليهم.
فقد أيقن كل منهم منذ “توزيره” أن البقاء في منصبه يقتضي بالضرورة حزاما صلبا من “الزبائن” البواسل، لذلك حرصوا على تأمين هذا الحزام، الذي وإن بدا بعض أفراده ديكورا أو لا يحترفون تقنيات تلميع صورة الوزير(ة)، فإن معاليهم كانوا خبراء بالتعهد والصيانة والترميم لحاشيتهم وحرسهم وهو ما ساعدهم، بعد سداد الفاتورة المُشطّة، على إخماد الأصوات خاصة في ظل استقالة الفاعلين وتآكل جهاز مناعتنا ككتاب ومبدعين من فيروس الإحباط الذي أصاب الساحة الثقافية برمتها.
لن نخوض كثيرا في ما رافق بعض التظاهرات طيلة عشر سنوات من إقصاءات لفلان أوعلان أو تكريمات شملت عمرو ولم تشمل زيد، لكن من المؤكد أن الأصوات سترتفع في قادم السنوات ولن تصمت على بعض السلوكيات في لجان الدعم أو لجان جوائز المهرجانات وذلك حتى يذهب الحق إلى أصحابه كأن ينصف كاتب أصدر ديوانه البكر أو أن يُكرّم في باب الاعتراف بالعامل المثالي مسؤولا أمضى وقته في ضبط مشروع وطني أو حارس ليلي (أعزل) بمعلم أو بمؤسسة يتربص بها المجرمون أو سائق تعطّلت سيارته بعيدا ونام في العراء.. أو أي مؤلف أو فنان تأكد أحقيته في دعم ما.
لا يسعنا في هذا السياق المقتضب إلاّ أن نترحم على شعور انتمائنا لهذه العشرية الثقافية.. وأن نُشفق على أنفسنا لما أصابنا من صمت وخنوع ولامبالاة.. وتلك عيوب جعلت منّا شهود زور وأطالت عمر هذا الترذيل والتهميش لعشرة أعوام.. وأن نهيب في الأثناء بالفاعلين في الشأن الثقافي أن يتصالحوا مع أنفسهم ومع بعضهم البعض حتى نرتقي بالفعل الثقافي.. وأيضا أن تكون الوزيرة الجديدة وطاقمها في مستوى تطلعات الساحة الثقافية بدءا بإعطاء حقوق بنات وأبناء القطاع وتشريك الكفاءات منهم –وهم كثّر- في مختلف التصورات، مرورا بمعضلة تداخل المهام داخل المؤسسة الواحدة وصولا إلى التعهد بالمؤسسات والمعالم وتحفيز القائمين عليها والإحاطة بالمبدعين ودعم مشاريعهم الفنية دون مفاضلة.. كل الأمل في استراتيجية ثقافية جديدة تكون صمام أمان لحماية بناتنا وأبنائنا من التطرف الإيديولوجي والفكر الظلامي المتربص بوطننا العزيز.